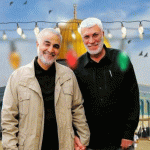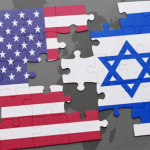منذ عقود وما يعتري المشهد الثقافي الناطق بالعربية محط متابعة لدى الكثيرين من المهتمين، وللمفارقة معظم هذه المتابعة خارج المنطقة العربية أصلا، وجزء من متابعتها يتموضع كرقم في معادلة لا علاقة لها أصلا بالأدب والثقافة، بل هي معادلة عامة في مسار واسع عريض تبدأ من الدراسة بغرض الفهم، وتنتهي بالدراسة لأجل التوظيف، وقطعا هذا الجزء الذي تقوده مؤسسات بعينها.
هذا المشهد خلال العقود الماضية لم يكن عفياً ولا متمتعاً بصحة، وفي المجادلة والنقاش بين اعتبار الأدب والثقافة رسولية، وبين اعتبارها مجرّد مرآة عاكسة كلام كثير، لكن المدهش أن حدي هذه المروحة الواسعة لا يولم يتمتعا بمؤشرات عوامل حيوية مرضية أو على الأقل غير مخيفة، بل الواقع أن عملية الضبط والتوظيف إياها وصلت لغايتها كاستخلاص وقصارى القول.
الآخرون وخاصة في أوروبا أنتجوا نصف أدبهم العميق واللافت في العصر الحديث، على ضفاف الحروب الكبرى وخاصة الحربين الكونيتين وما شهدتاه، وأنموذج التفوق كان طبعا الروسي واللاتيني وجاء بعدهما بمراحل الأنجلوسكسوني فالجرماني، والدراسات الاجتماعية الأدبية، أو الأدبية الاجتماعية، بمضامينها المختلفة بما فيها الفلسفية، طاردت هذه الظاهرة بتمعّن وتركيز، فخلصت إلى أن الكوامن الإنسانية مثلها مثل الكوامن الطبيعية قابلة للتفجير والتدفّق عقب وأثناء الخراب.
في المشهد العربي عقب الطوفان ومنذ تشرين اول 2023 يبدو أن هذا الاستنتاج لا يخص العروق الناطقة بالعربية، حتى تلكم المستشرقة منها، فالصمت والتواضع في التعبير الإنتاجي، هو صيغة التعميم المشاهدة الوحيدة في الصورة المقروءة والمشاهدة، وقطعا ثمة من سيجادل أن الوقت ما زال مبكرا لمثل هذا الحكم والذي قد يصفه بالمتسرّع أو الظالم، ولا مشكلة لدينا في هذا الاتهام بشرط أن تكذّبه الوقائع التي يعترض لها المعترضون!
عند متابعة المشهد الثقافي الناطق بالعربية منذ انفجار الطوفان وحتى بعد عام ونصف، تصيب المتابع الدهشة، فالمادتان الثقافيتان الأساس شعرا ونثرا من جهة، وتشكيلاً وموسيقى من جهة أخرى، بدتا عاجزتين عن إنتاج أي من المراحل الأساس: المواكبة والاستشراف والتغيير، هذا فضلا عن أن الإنتاج يمكن وصفه بالمحدود، بل بالمحدود جداً، ولم تؤجج الأحداث الكبرى التي تمر بها المنطقة العربية ومركزها فلسطين أي نار سوى نار الخيبة.
هذا الاستنتاج ليس محصورا بالمشهد الثقافي الفلسطيني فقط، وهو على كل حال كان يجب أن يكون موازيا في خندقه الثقافي لما هو وضع نظيره القتالي في الميدان، بل هو ممتد حكما حتى بقايا الصورة للمنطقة العربية بأسرها، وصولا إلى العربية المهاجرة في الأصقاع والبلدان، حيث بدا وكأن عنّة تامة أصابت محركاتها، وهو أكثر من الصدمة بكثير، وباستثناءات محدودة في هذه الصورة العامة، وصل إنتاج محدود أغلبه متواضع أو غير ذي بال، والمدهش الأكبر أن المادة الحاملة أساسا والمفترضة لهذا المنتج وهي الوسائل الحديثة للاتصال والتواصل، حفلت باقتباسات يومية بكل الأشكال الممكنة من عهد آدم حتى عهد جيفارا!
الثقافة ليست مؤسسة، ومع ذلك كان الفارق الأساس بين الثقافة العضوية والمصنوعة هو دور المؤسسات، والمؤسسات جميعها بشتى أشكالها من الوزارات إلى شركات التحكم بوسائل التواصل المجتمعي، كلها تحت الضبط وفي خدمة ذلك الغرض أيا كان موقعه، لكن ينسى المثقفون أن المؤسسة الحقيقية لما ينتجون هي الشعب نفسه، وهذا دورهم أصلا في التلاحم معه، فهو حاملهم ومحمولهم معاً، ولكنهم يذهبون حيث المؤسسات الأخرى التي كما هو مفهوم تعدهم بالمادة عوضا عن الأصلانية والعضوية!
ثمة من جادل مطولا قبل هذا الوقت أن وسائل التواصل نفسها كبديل واقعي للمهرجانات والشاشات هي المتحكم وهي البديل، وهذا غير صحيح مطلقا، فما شهدته وسائل التواصل من تناقل المقتبسات القديمة بمروحة واسعة من النص القرآني والنصوص المرجعية، إلى الحكم والقصص، إلى القصائد القديمة، والتشكيلات، والبوستر، والأغاني، بل وحتى الكاريكاتير، مواكبة للطوفان يثبت أن وسائل التواصل هذه كانت سوقا غابت عنها عكاظ، هذا بالمفهوم المتدني والذي لا ننكر أنه موضع اهتمام كثيرين من لابسي أطقم الثقافة، شئنا أم أبينا.
سيجادل آخرون بأن الضبط وأحيانا القهر، هي موانع وكوابح قاتلة للإنتاج فضلاً عن الإبداع، وهذا قد يكون صائبا في تفسير الكم، لكنه غير صائب في تفسير الكيف المتواضع الذي تابعناه، فضلاً عن أن المدهش في الحكاية لم يكن فقط في استتار الصورة إياها، بل تحديدا في غياب أولئكم الذين زعموا الرسالية والرسولية في الثقافة والأدب والفن فترة طويلة قبل الطوفان، ليقبلوا أن يتجاوزا البيات الشتوي إلى البيات الفصلي الكامل على طول العام والنصف.
مع كل هذا الدسم الفوضوي في الصورة، إلا أن هناك علامات مضيئة في الصورة ربما وحدها تصبح لاحقا عكازا حتى لا تسقط صورة الواجب على الأقل في هذه المنظومة المخيّبة للآمال، ألا وهي الأصوات والنتاج الذي صدر بلغة غير العربية ولكن من فلسطينيين تحديدا وربما فرساً وتركاً في أقل من هذا، فقصائد الشهيد رفعت العرعير وحدها شكلت نقطة مضيئة في كل هذه العتمة والتي كتبها وأرسلها للعالم باللغة الإنجليزية التي درسها ودرّس أدبها، تماما كما كانت أغنية واحدة بنيت على كلمات صحفي فلسطيني وائل الدحدوح اغتالت إسرائيل أكثر من نصف عائلته قادرة أن تصل وتحقق بؤرة.
بالمجمل نحن لا نعوّل أصلا على المؤسسة أي مؤسسة، سواء أكانت وزارة أم مبثّة فضائية أو أرضية، سيما الفلسطينية منها والتي أثبتت زبائنيتها وخيبتها مراراً، باختصار هذه جميعها ليست إلا أشطان، المبدع العضوي يعلم ذلك ، ولذا فهو لا يضعها باعتباره، وهو إن كان فلسطينيا لن يكون قدوة له إلا عبدالرحيم محمود أو غسان كنفاني أو ناجي العلي أو علي فودة أو حتى شيرين أبو عاقلة، ومن أمثالهم من الشهداء، لن يكون قدوته هذا ولا ذاك من جماعة الحبال الملقاة بين أيدي المؤسسات على أنواعها، والمخزي أن تذكر ما تسمى مؤخرا بغير الحكومية وهي مراكز استثمار مخابراتي أجنبي خفي.
وفي مهمة من نوع إيقاظ تختلف عن مهمة من نوع ندب ونواح وختمة أو قداس وجناز وانتهى، ولذا لا زال لدينا أمل ما ولو كان منسوبه في القعر، بيد أنه متوفر، نحن لا يمكن أن ننسى في مرحلة سابقة الصورة المقبولة والتي شهدتها الساحة مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى مثلا وحتى الثانية، ليس فقط فلسطينيا وعربيا بل حتى دوليا، إن كلمة انتفاضة بحد ذاتها أصبحت مفردة عالمية، كما سبق مفردة نكبة وكما لحق بمفردة طوفان، أنا لا زلت أنتظر أن يفاجئني المشهد الخامد بنوع حركة ما لا يطمئن فقط، بل ليشي بأن التغيير ممكن، وأن نصرا ممكن تحقيقه في هذه الجبهة المتعبة المتهالكة، أي الجبهة الثقافية، ونحن إذ نتابع المشهد العام، لنحلل وندرس ونستخلص وربما لنحرّض على الابداع الحقيقي، فإننا قطعا نأخذ ما تقوله براغي ومسننات المؤسسات ضمن المحصول، لكننا نفصله في النهاية لأننا لا نبحث عن الزوان بل نبحث عن القمح، وهذا ما سيفهمه كل فلسطيني!