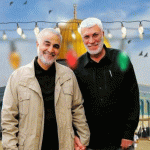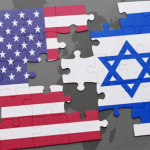الخطاب الأميركي حول سيادة الدولة واحتكار السلاح بوصفه جزءاً من مقاربة أمنية إقليمية أوسع، لا مشروعاً وطنياً عراقياً خالصاً . فالولايات المتحدة، التي تتحدث اليوم عن دولة قوية ومؤسسات منضبطة، هي ذاتها التي أسّست بعد 2003 لنظام سياسي هشّ، قائم على التوازنات القلقة، ومفتوح على كل أشكال الاختراق الداخلي والخارجي. لم يكن بناء الدولة يومًا أولوية حقيقية بقدر ما كان الهدف إدارة الفوضى بما يخدم المصالح الأميركية ويمنع تشكّل قوة عراقية مستقلة قادرة على اتخاذ قرار سيادي حر .
إن حصر السلاح، وفق الرؤية الأميركية، لا يُطرح ضمن سياق إصلاح أمني شامل يعالج جذور الأزمة، مثل ضعف المنظومة الدفاعية الرسمية، أو غياب عقيدة وطنية موحّدة، أو تسييس المؤسسة العسكرية. بل يُطرح كإجراء انتقائي، يركّز على تفكيك قدرات بعينها، وتحييد أطراف محددة، دون المساس بالبنى العميقة التي أنتجت هذا الواقع. والنتيجة ليست دولة قوية، بل دولة عارية، منزوعة القدرة على الردع، ومكبّلة الإرادة .
الأخطر من ذلك أن هذا الطرح يُسقِط من حسابه حقيقة الموقع الجيوسياسي للعراق. فالعراق ليس دولة هامشية يمكن عزلها عن صراعات الإقليم، بل هو نقطة تماس مركزية بين مشاريع كبرى: أميركية، إيرانية، تركية، وخليجية. وفي هكذا بيئة، لا يمكن لأي دولة أن تحافظ على سيادتها من دون امتلاك عناصر قوة ذاتية، سواء كانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية. نزع هذه العناصر تحت شعار الاستقرار لا يقود إلا إلى تكريس التبعية وتحويل البلاد إلى ممرّ آمن للآخرين .
ومن هنا، فإن الإصرار الأميركي على هذا المسار يعبّر عن خشية استراتيجية، لا عن حرص أخلاقي. واشنطن تدرك أن أي تصعيد محتمل مع إيران سيجعل من العراق ساحة اشتباك محتملة، لا بحكم رغبة العراقيين، بل بحكم الجغرافيا وتشابك المصالح. ولذلك، فهي تسعى إلى تحييد أي قوة عراقية قد تُربك حساباتها أو تفرض معادلات ردع غير محسوبة . العراق، في هذه الرؤية، يجب أن يبقى مساحة حركة، لا طرف قرار .
غير أن المفارقة تكمن في أن هذا النهج ذاته يُضعف الدولة العراقية التي تدّعي الولايات المتحدة دعمها . فالدولة التي تُمنع من امتلاك أدوات الدفاع عن نفسها، وتُفرض عليها خيارات أمنية من الخارج، تتحول تدريجيًا إلى كيان شكلي، يعتمد في بقائه على التوازنات الدولية لا على شرعيته الداخلية. وهذا ما يفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات، ويغذّي الشكوك الشعبية حول مفهوم الدولة ذاته، باعتبارها مشروعًا مفروضًا لا معبّراً عن الإرادة الوطنية .
ولا يمكن إغفال البعد الداخلي في هذه المعادلة. فالنقاش حول السلاح غالبًا ما يُختزل في ثنائية الدولة والفصائل، متجاهلاً أن الأزمة أعمق من ذلك. إنها أزمة ثقة بين المجتمع والدولة، وأزمة تمثيل سياسي، وأزمة عدالة اجتماعية . في ظل غياب مشروع وطني جامع، يصبح السلاح مهما اختلفنا حوله انعكاساً لفراغ الدولة لا سببًا له . معالجة النتيجة دون معالجة السبب لن تنتج إلا مزيدًا من الاختلال .
إن بناء دولة حقيقية في العراق لا يبدأ بنزع السلاح بقدر ما يبدأ بإعادة تعريف السيادة، وتحرير القرار السياسي من الارتهان الخارجي، وبناء اقتصاد مستقل، ومؤسسات قادرة على استيعاب التنوع دون تحويله إلى صراع. عندها فقط يصبح الحديث عن احتكار السلاح حديثًا منطقياً ، نابعًا من الداخل، ومقبولاً مجتمعيًا، لا شرطًا مفروضاً من الخارج لخدمة حسابات لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية .
في المحصلة، ليست المشكلة في شعار حصر السلاح بيد الدولة بحد ذاته، بل في السياق الذي يُطرح فيه، والغاية التي يُستخدم من أجلها. فإذا كان الهدف حماية العراق، فليُمنح حقه الكامل في السيادة والقرار. أما إذا كان الهدف حماية المصالح الأميركية، فحينها يصبح العراق مجرد تفصيل في معركة أكبر، لا يُطلب منه إلا الصمت والاستقرار القسري. وبين هذين الخيارين، يقف العراقيون أمام سؤال مصيري .. أي دولة نريد؟ دولة تُدار من الخارج، أم دولة تصنع توازنها بيدها، وتدفع ثمن استقلالها بوعي، لا بوهم الحماية .