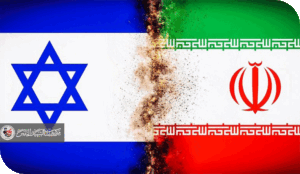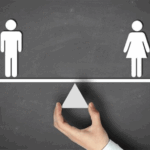تتصاعد بين فترةٍ وأخرى في الواقع الثقافي المعيش، نبرةُ التململ من بعض النُقّاد – وأعني بهم، من يكتب في المشغل الأدبي من دراسات وبحوث ومقالات حول متون أدبية أو نقدية – إزاء ما يتحسّسون منه من تفضيلٍ لآخرين عليهم، في تقديمهم عليهم في بعض المناشط الثقافية، وذلك لما يمتازون به من صفة “الأكاديمي” ويُراد بهذه الصفة كُل من نال شهادةً عليا في تخصُّص النقد الأدبي، فكان بموجبها أن يسبق أسماءهم حرف الدال، وهي اختصار لصفة حامل الدكتوراه، قد يكون الأمر غريبًا بعض الشيء، وفيه من اللبس، بما يتطلّب الخوض في تفاصيله. وهنا لا بدّ لمن يتأمّل هذه الظاهرة في الوسط الثقافي، أنْ يتقصّى أسبابَها، ويضعها على طاولة التشريح النقدي؛ لأجل أن لا يكون الحكمُ بعدَها مجانيًّا لمُجانبته الصواب.
وقبل الخوض في واحدٍ من أهم الكتب التي يُمكن أنْ تكون دليلاً لمن يذهب بزوال النقد الأكاديمي وأفول مكانته، علينا أنْ نُشير تاريخيًّا أنَّ كلمة (أكاديميا) اليونانية في أصولها تدلّ على كونها “منهاج للبحث العلمي يلتزم بقواعده الباحث التابع لإحدى الجامعات الرسمية” . والالتزام بهذا المنهاج بحذافيره من قبل الباحث، قد يكون في بعض الموارد سببًا لإدانته والتقليل من قيمة المعرفة التي ينتجها أو يتوصل إليها، باعتبار أنّ المعرفة ليست منجزًا قارًّا يخضع لقواعد ثابتة، فيتطلب إذن باحثًا ألمعيًّا يُقدِّر هذه الخصوصية، لا يرتهن لهذه النمَطية والرتابة في تناوله الظواهر ورصدها والبحث عن تشكّلاتها أو العوامل التي أدّت إلى نشوئها .. الخ بقدر ما يرتهن إلى حدّة ذكائه وفطنته في التعامل مع تلك القواعد، بما يُدلل على موضوعيّته التي تدعوه لتكريس ما لديه من خبرة علمية في البحث العلمي في المجال الذي تخصص فيه، ولمّا كان حال الأعمّ الأغلب في المؤسسات الأكاديمية ممّن يتقيّد بضوابط البحث العلمي الصارمة ويتوقّف عندها، صارت هذه القواعد “محل انتقاد من قبل الكثيرين من العلماء والباحثين الذين يعتقدون أن قواعد البحث الأكاديمي تبتعد كثيرا عن البحث العلمي الموضوعي، إذ يعتبرون أن أساتذة الجامعات هم أبعد ما يكون عن التجرد التام للعلم، كذلك يعد هؤلاء العلماء المنتقدون للأكاديمية أن آليات البحث الأكاديمي تقلل من رأي الباحث وحرية الرأي، وتمجد من المصادر وترفع من قدسيتها وتغالي في التوثيق على حساب متن البحث نفسه” .
وإذا كانت الرتابةُ والنمَطيّة صفةً لكثيرٍ من الدراسات، بفعل أسبابٍ كثيرة مختلفةٍ في منازعها، فإنَّ ذلك لا يمنع من ظهور الجيّد بل المائز في بعض الدراسات الأكاديمية – في مختلف الحقول المعرفية – بفعل توافر العامل الذاتي ممثّلاً بذكاء الباحث وموهبته في ذلك الجانب من جوانب المعرفة، والتقائه بالعامل الموضوعي ممثَّلاً بالدرس الأكاديمي الذي صقلَ تلك الموهبة، وارتقى بها لما هو أفضل، فحلَّقَ بها إلى مصافِّ الإبداع في الكتابة البحثيّة الناضجة التي تناقش أفكار السابقين وتنقده، وتطرح في قباله الجدير بالأخذ والتبنّي بما له من قوّة حجّة، أو إتاحة أفقٍ جديد من الفهم أو التحليل، أو كشف حقائق في ذلك الحقل لم يتوصّل لها السابقون، بما يُحسَبُ من إنجازٍ لذلك الباحث الأكاديمي على سواه مرُّوا على تلك المقولات والأفكار مرور الكرام من دون أنْ يُحرِّكوا ساكنًا أو يضيفوا شيئًا جديدًا في تلكم الدراسات، وهو أمرٌ لا يخفى على كل من يُطالع المشهد الأكاديمي بإنصاف وموضوعية.
عالميًّا، يمكن أن نجدَ مستوىً آخر من هذه الظاهرة ولكنّه قريبٌ منها، يتمثَّلُ بما وصفه “رونان ماكدونالد” بـ”موت الناقد” من ظاهرةٍ ثقافيّةٍ أخذت تكتسح بعد المظاهرات الطلابية في پاريس عام 1968 ضد الحرب الأمريكية على فيتنام آنذاك، تمثّلت بالتمرُّد على الأُطُر الأكاديمية الضيّقة آنذاك، ومن أجلى مظاهرها تضييق الخناق على مكانة الناقد الأدبي الأكاديمي في المجتمع، وصولاً إلى إلغائها تمامًا، باعتبار أن السلطة بيد القارئ، وهو المرجع في تحديد ما يريده المؤلف، ولأن المؤلف في نظر “رولان پارت” قد مات، بما لا يدع له مجالاً في ممارسة سلطته على نصِّه، فلْيَمُتِ الناقدُ أيضًا، وليس ثَمَّةَ سلطةٌ هنالك حينئذ، غيرُ سلطة القارئ، “فلم تعد أصواتُ زمرةِ النُخبةِ المُكوَّنةِ من عددٍ من السادة المتقدِّمين في السِنِّ الذين يعملون في الجامعة، والذين يُملُون علينا ما ينبغي أن نقرأ وما لا ينبغي، تلقى آذانا صاغية وسط المتاريس” ، ولأن القراءة في عُرف پارت هي “عملية سلسة مسترسلة مفتوحة لها طابعٌ فرديٌّ، لا تحتاج إلى معرفة ما يقصده المؤلف لكي تكتسب مشروعيتها.
فإذا كنتَ تريد مهاجمة السلطة authority فوجه سهامك إلى المؤلف author بالنسبة لبارت،فإن النظر بشيء من التقديس إلى قصد المؤلف هو أمر حديث نسبيا، وهو ظاهرة ما بعد تنويرية علينا أن نتجاوزها”.
ولا بدَّ لنا ونحن نقرأ تسويغ پارت لعملية القراءة، أن لا نُماهي بينه وبين ماكدونالد، فهو هنا ينقل لنا ما قدّمه پارت، من تسويغ بموجبه دفع مكانة الناقد – بوصفه قارئا مُتقدِّمًا للنص – عبر حركة شطرنجيّة – إن صحّ الوصف – تتمثَّل بموت المؤلِّف، فإن كان المؤلف – صاحب النص – لا يملك وصايةً على نصِّه، في تحديد دلالةٍ يقصدُها دون أخرى، فمن بابٍ أَولى، أن الناقد لا يحقُّ له، أنْ يملكَ تلك الوصايةَ فضلا عن ممارستها إزاء القارئ العادي، فلا تقديس لقصد المؤلف، وضِمنًا لا تقديس لما يتوصّل الناقد إليه في قراءته، ولا خصوصيَّة لها، فالكلُّ – من قارئٍ متخصِّص “ناقد” وقارئٍ غير مُتخصِّص – لا يحتاجون إلى معرفة ما يقصده المؤلِّف؛ لأن القراءةَ في نظر “پارت” بحسب وصفه الآنف “عملية سلسة مسترسلة مفتوحة لها طابعٌ فرديٌّ” وهو تبسيطٌ لا تخفى سطحيّتُهُ لكلِّ مُنصفٍ يُدرك أهمية الناقد الأدبي وتميُّزِهِ على سواه من القُرّاء، بدعوى أن القراءة نشاطٌ لا يحتكرهُ أحدٌ دون آخر، وعليه – بحسب هذا التبسيط الاختزاليّ – فإنَّ ما يتوصّلُ إليه القارئ العادي غير المُسلَّح بدراية ومعرفة بالنص، قد لا تكون دائماً أقلَّ رُتبةً إزاء ما يتوصّلُ الناقد المحترف مع ذلك النص.. ! بل يمكن أن ينافسه ويفوقه. ويستمرُّ بالتأسيس لفكرته التي تقضي بعدم الحاجة إلى وجود ناقد يمكن التعويل عليه في بيان قيمة النص من عدمه بما يمتلكه من ثراءٍ معرفيٍّ في ذلك التخصُّص، يُؤهِّلُه لتلك الرُتبة، بالقول بحسب ما ينقله ماكدونالد عنه: “إنَّ كلَّ اعتراضٍ على مُقاربةٍ نقديةٍ ما بالقول: “ليس هذا ما عناه المؤلف” يسعى إلى الحدِّ بصورةٍ غيرِ مشروعةٍ من خصوبةِ اللغة والتعدُّديةِ المُمكنة للمعاني في عملٍ أدبيٍّ بعينه” .
وفي كلام پارت تعميمٌ لا يخفى بُطلانُهُ لكلِّ من يتأمّل فيه، فالتعدُّدية المُمكنة للمعاني التي يُلوحُ بها “پارت” بوصفها علامةَ صحّة وتجدُّد للنص – وهذا ما لا يختلف عليه العقل الذي يؤمن بمنطلقات التنوير وانعكاسها على مجمل حقول المعرفة – قد لا تكون صحيحةً في حال لم تتحقّق في ذلك القارئ “العادي” المؤهِّلات المعرفية الكافية للوصول إلى ذلك التعدُّد، وليس من الصواب أن نقبل تحت عناوين برّاقة، مثل: (الحُرّية، التعدُّدية، الديمقراطية، قبول الآخر) إذ سيكون ذلك الاستسهال في فتح الباب أمام الكل بوصفهم قُرّاءً للنص لا ميزةَ لأحدٍ على سواهم، سببًا في تخبُّط القراءات بعضها بالآخر، وتضيع بموجبه الغاية من القراءة، إذ الكلُّ يرى أنه وصلَ إلى المعنى الذي يُريدُهُ المؤلف، وليس من حقِّ أحد أنْ يعترضَ على قراءاتٍ لم يتوافر عند أصحابها القدرُ الذي يُؤهِّلُه للتفرُّدِ بقراءته وما تُوصلُهُ تلك القراءةُ من دلالة..
وإذا أردنا التأكّد من قصد رولان بارت، يذهب باتّجاه نقد النظرة التقليدية التي تمسّك بها كثيرٌ من أساتذة الجامعات آنذاك، بعيدًا عن الاتّجاهات الجديدة التي كان بارت أحد دعاتها، هذا لأنه في الوقت الذي انتقد الأكاديميين من النقّاد، كان يُمارس التدريس الأكاديمي، إذن فليس مشكلتُهُ مع الأكاديميين لأنهم أكاديميون مثلما يظنُّ البعض، بل يقف منهم موقف المعارضة لأنّ دراساتهم “النقدية الأكاديمية التي تتمسّكُ بمحكّات ومعايير أكاديمية بالية أدّت إلى ظهور تفسيرات سيكولوجية ساذجة وفجّة، وبخاصّة حين كان الناقد يُحاول تفسير مادة (النص) بالرجوع إلى حياة الكاتب” . ومن هنا تأسّست لديه مقولة (موت المؤلف) انطلاقًا من تفسيره للنص وتأويله، وبالمحصّلة يمكن أنْ نلمس موقفه الناقد لهؤلاء النقّاد لا لأنهم نُقّاد أكاديميون مثلما يتوهّم بعض الذين انتصروا لمقولة “موت الناقد الأكاديمي”، بل لأنهم لم يُواكبوا المعاصر من المناهج النقدية التي تُتيح لهم فضاءً أرحب في قراءة النص وتأويله، الأمر الذي دفعه لأن ينتقدهم بطريقةٍ يُفهم منها أنّه ضد مكانة الناقد الأكاديمي بصورةٍ مُطلقة. ومن الجدير بالذكر أنَّ مقولة (موت المؤلف) قد استوقفت الناقد الدكتور هشام زغلول في مقدمة ترجمته كتاب فنسنت ب.ليتش بالقول: ((وهي مقولة قائمة على تصوُّرٍ مغلوطٍ لعلاقة النقد الأدبي بالنقد الثقافي، تلك العلاقة التي تصوُّرها البعض – من منطقٍ أحادي – قائمة على الإحلال والإبدال؛ فقال ما قال، ثم تداولها آخرون حتى انتشرت في أوساطنا النقدية انتشار النار في الهشيم. وهي مقولة تلحق بسلسلة الموت التي شهدها أطراف المنظومة النقدية، فمن موت المؤلف لموت الناقد لموت النقد نفسه؛ في متوالية بدت مغرية لكثيرين)) ، بما يؤكّد للمتأمّل ما سبّته هذه المقولة من تأويلاتٍ عدّة لم تقع في محلِّها المناسب، بل أكثر من ذلك، أخذها من اتجّه بها إلى ما لا تريدهُ هذه المقولات من معانٍ واستخدامات جعلت من هبَّ ودبَّ يحتجُّ بها فيما يزعمُهُ من دلالة ما كان لها أنْ تقرّ في ذهن الذي أطلقها لأولّ مرة.
ولا يخفى على من طالع سيرة الناقد “رولان بارت” والقفزات النوعية التي حقّقها من مشروعٍ ثقافي لآخر، فلا يحقّ له أنْ يقف عند موقفه الناقد من “النقد الأكاديمي” هذا لأنّه يُعدُّ واحدًا من مواقفه التي لم يبق ثابتًا عندها، فتعميم هذا الموقف واستلاله بوصفه موقفًا عامًا ثابتًا لرولان بارت، يُعد مُصادرةً على مواقفه التي وُصِفت بالمُتعدِّدة، بل المتناقضة، فقد ذكر جوناثان كولر، أنَّ شخصيّته كانت محمّلةً بالتناقضات، إذ يمتلك مجموعةً معقّدةً من النظريات والمواقف، وهو لهذا السبب لا يُمكن حصر مجال اختصاصه في النقد الأدبي دون سواه من مجالات، “فتأثيره يرتبط بالأحرى، بالمشروعات المتنوِّعة التي وضع خطوطها العريضة وتبنّاها، وهي مشروعات ساعدت في تغيير طريقة تفكير الناس في مجموعة متنوعة من الموضوعات الثقافية من الأدب، والموضة، والمصارعة، والدعاية، وحتى التصورات عن الذات، والتاريخ، والطبيعة” ، وممّا يؤكّد على تناقضاته، أنّه كان يُشجّع قارئيه على تأمّل أطروحاته أو تطويرها أو دحضها، بحسب ما نقله كولر من استدعاءات لبارت في كتابه السِيَري “بارت بقلم بارت” تؤكّد ما كان يُمرُّ به من تبديلٍ لأفكارٍ طرحها في مشاريعه الفكرية السابقة، ويصفها بالهذيان. وكأنه “يستمتع بادّعاء أنَّ كتابته لا تتأسّس على نظريّات ذات شأن، وإنما تقوم – بدلا من ذلك – على هذيانات سريعة الزوال، ولا يرتكز صيتها على قيمتها المعرفية بل على افتتاناتها المفهومية وحماساتها المتتالية” . وهذا ما يُتيح فرصةً لمناقشة أفكار الرجل، ونزع مقولاته من رداء القداسة، باعتبار أنّها نسبيّة غير صالحة للتعميم في كل الأحوال. وباعتبار أنّه – صاحب الشأن – تعامل مع أفكاره السابقة وفقًا لهذا المنطق النسبي، وهو المنطق الذي يجنح إليه الفكر الناقد الذي يُؤرّقه السؤال وعدم الركون إلى البديهيّات.