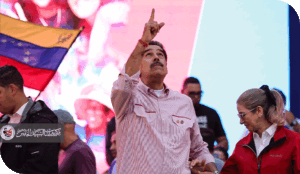بالنسبة للعديد من الإيرانيين، كانت الحالة السائدة في نهاية عام 2025 هي اليأس. فقد عانت البلاد من عامٍ من الحرب والانهيار الاقتصادي والأزمة البيئية. كانت الحكومة مشلولة، وعجز قادتها عن تغيير المسار بسبب ضعفهم أو تمسكهم بالأيديولوجيا أو عدم كفاءتهم (وفي بعض الحالات، جميع هذه العوامل مجتمعة). لم يكن الأمر سوى مسألة وقت حتى يؤدي هذا اليأس إلى جولةٍ أخرى من الاحتجاجات الجماهيرية. والسؤال الوحيد كان ما الذي سيشعل شرارتها.
جاءت الشرارة من جهةٍ غير متوقعة في 28 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، عندما أضرب بائعو الإلكترونيات في طهران. كانت مطالبهم واضحة: معظم بضائعهم مستوردة، ومن الصعب شراء وبيع السلع المستوردة عندما تكون العملة في حالة انهيارٍ حر. لكن الاضطرابات سرعان ما انتشرت. وحذت حذوهم شركاتٍ أخرى، بما في ذلك التجار في السوق الكبير في العاصمة (البازار)، والذي يُعتبر مؤشرًا على الوضع السياسي في إيران.
بدأت الاحتجاجات في شوارع طهران وسرعان ما امتدت إلى أصفهان وشيراز ومدنٍ كبيرةٍ أخرى. وأصبحت هتافاتهم أكثر سياسية: “الموت للديكتاتور” وليست مجرد دعوة إلى استقرار سعر الصرف. في إحدى المدن الريفية في الجنوب، حاول الناس اقتحام مبنى البلدية. في 31 كانون الأول (ديسمبر)، صدرت أوامر بإغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في 21 من أصل 31 محافظة إيرانية. رسميًا، كان الهدف المُعلن من الإغلاق هو توفير الطاقة خلال موجة البرد. لكن العديد من الإيرانيين رأوا فيه خطة لإبقاء مثيري الانتفاضة المحتملين في منازلهم.
لم تكن المظاهرات ضخمة – آلاف الأشخاص، وليس ملايين كما في عام 2009 – لكنها الأكبر منذ عام 2022، عندما هزت إيران احتجاجات بعد وفاة شابة تم اعتقالها بسبب ملابسها “غير اللائقة” (أي ظهورها بشعرٍ مكشوف) أثناء احتجازها لدى الشرطة. يقوم النظام بقمع الاحتجاجات بشدة في المدن الصغيرة، لكنه تجنب حتى الآن المواجهة المباشرة في المدن الكبرى. ومع ذلك، قُتل عدة أشخاص واعتقل أكثر من 100 شخص.
لدى الإيرانيين الكثير من الأسباب للغضب. لقد فقد الريال أكثر من 40% من قيمته منذ حزيران (يونيو) الماضي، عندما خاضت إيران وإسرائيل صراعًا دام 12 يومًا. وفي الشهر الماضي، وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.4 مليون ريال للدولار. وعلى الرغم من أن الحد الأدنى للأجور تضاعف تقريبًا خلال العامين الماضيين، إلا أنه لا يزال بالكاد يصل إلى دولارين في اليوم. بلغ معدل التضخم أرقامًا مزدوجة لسنوات، وهو الآن يتجاوز 40%. يُضاف إلى ذلك النقص المزمن في الطاقة والمياه: فقد عانت البلاد من انقطاعاتٍ متكررة للكهرباء لعدة أشهر، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حذر الرئيس مسعود بيزشكيان من أنه قد يتعين إخلاء أجزاء من طهران إذا استمر نقص إمدادات المياه.
إن بدت هذه المظالم مألوفة، فليس ذلك مستغربًا. فقد غذّت شكاوى مماثلة موجات احتجاجية كبيرة أخرى، بما في ذلك في عامي 2017 و2019. في الواقع، قد يكون من الخطأ اعتبارها أحداثًا منفصلة. فبعد ما يقرب من 50 عامًا على الثورة الإسلامية، أصبحت إيران دولة تعيش حالة من الاضطراب، مع اندلاع تظاهراتٍ كبيرة كل بضع سنوات، وعشرات من الاضطرابات الأصغر بينها.
وعد الرئيس مسعود بيزشكيان بالإصلاح عند انتخابه في تموز (يوليو) 2024، لكن من الصعب إصلاح بلدٍ يحكمه رجل دين يبلغ من العمر 87 عامًا ويرفض التغيير. فالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لم يقدم التنازلات الكبيرة اللازمة بشأن برامج إيران النووية والصواريخ الباليستية التي قد تُمهد الطريق لاتفاقٍ مع الولايات المتحدة، وبالتالي رفع العقوبات الاقتصادية.
كان بعض المسؤولين يأملون أن تُحدث الحرب مع إسرائيل تأثيرًا دائمًا من شأنه أن يُوحّد الصفوف ويُخمد المعارضة. وقد تخلت الحكومة إلى حدٍ كبير عن فرض ارتداء الحجاب على النساء، وهو مصدرٌ رئيسي للغضب الشعبي، ولجأت إلى الاعتماد على القومية الإيرانية العلمانية، حيث ملأت العاصمة بلوحاتٍ إعلانية تُصوّر أبطالًا من حقبة ما قبل الإسلام. لكن لم يُفلح أي من هذا: فالمشكلة الحقيقية، بالنسبة لمعظم الإيرانيين، هي تدهور مستوى معيشتهم بشكلٍ مطرد.
لا يستطيع الرئيس الإيراني سوى إجراء تغييرات هامشية. ففي 29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أقال محافظ البنك المركزي غير المرغوب به شعبيًا وعيّن مكانه السيد عبد الناصر همتي، وهو اقتصادي ومحافظ سابق للبنك المركزي. ومن المفارقات أن السيد عبد الناصر همتي كان قد أُقيل من منصبه السابق كوزير للاقتصاد في آذار (مارس) الماضي، بعد أن وجه إليه نواب محافظون اتهامات بسبب ارتفاع معدلات التضخم. ويُشبّه أكثر من إيراني هذا التغيير بإعادة ترتيب كراسي السفينة على متن سفينة تيتانيك الغارقة.
وإن بدا النظام مُضطربًا، فإن المعارضة تبدو كذلك أيضًا. فلكي تنجح الاحتجاجات، عادةً ما تحتاج إلى بعض المكونات: الحجم، والقيادة، والقدرة على إحداث انشقاقات داخل النخبة الحاكمة. ولا يتوفر أي من هذه المكونات في إيران. ورغم استيائهم، يُفضّل معظم الإيرانيين البقاء في منازلهم. فالحركة الاحتجاجية غير منظمة وبلا قيادة، ولا توجد أي مؤشرات حتى الآن على انشقاق شخصيات نافذة عن النظام. كل هذا يُشير إلى أن الاضطرابات الحالية ستتلاشى أو سيتم قمعها، كما حدث في الجولات السابقة.
مع ذلك، هناك عاملان غير متوقعين هذه المرة. أحدهما بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يبدو حريصًا على شن جولة أخرى من الضربات الجوية ضد إيران، التي تُحاول إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية بعد الأضرار التي لحقت به جراء ضربات حزيران (يونيو) الماضي. وكان هذا الموضوع على جدول الأعمال عندما زار نتنياهو الرئيس دونالد ترامب في منتجعه في مارالاغو في ولاية فلوريدا في 29 كانون الأول (ديسمبر). وقد يُعيد شبح الحرب تشكيل السياسة الإيرانية بطرقٍ يصعب التنبؤ بها.
وكذلك قد يُؤثر احتمال التدخل الأمريكي. ففي 2 كانون الثاني (يناير) الجاري، حذر الرئيس ترامب إيران من قمع المتظاهرين. وكتب: “إذا أطلقت إيران النار وقتلت المتظاهرين السلميين بعنف، وهو ما اعتادت عليه، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل لإنقاذهم. نحن على أهبة الاستعداد”.
وكما هو الحال دائمًا مع تصريحات الرئيس الصاخبة على وسائل التواصل الاجتماعي، من الصعب معرفة ما يُقصده. لكن لدى إيران أسباب وجيهة لأخذ تهديدات الرئيس ترامب على محمل الجد: فقد قتل جنرالًا إيرانيًا خلال ولايته الأولى، وقصف منشآتها النووية في ولايته الثانية. وقد قتلت إيران بالفعل متظاهرين؛ وإذا تصاعدت الاحتجاجات، فمن شبه المؤكد أنها ستقتل المزيد. إذا تجاهلت إيران هذا التحذير، فهل سيفي الرئيس ترامب بوعده حقًا؟ وماذا قد يترتب على ذلك؟ لا أحد يعلم.