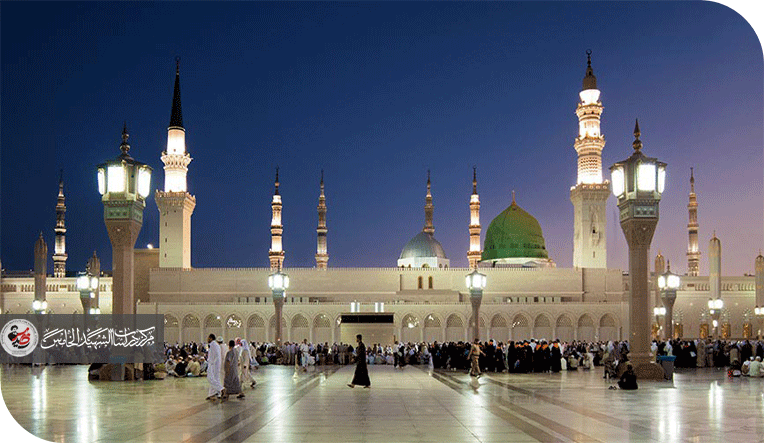كأنّ الرحمة ليست صفةً من صفات الله فحسب، بل الحبر الذي كتب به الوجود، الضوء الذي أُشعلت منه النجوم، والسرّ الذي إذا لامس الروح أعاد تشكيلها من جديد. إنّها الومضة التي سبقت الخلق، والدفء الذي سيبقى بعد أن تطفئ القيامة أنفاسها.
رحمةٌ لا تُقاس بالمقاييس الأرضية، بل تُشاهد—إن شُوهدت—من وراء الستار، في ذلك الفضاء الذي تتلاشى فيه حدود العقل أمام فيوض النور.
قال تعالى: «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ»،
فكأنّ الله يخبر الكون كلّه بأنّ الرحمة ليست شيئًا يلحق بالأشياء، بل هي الشيء الذي يحتويها جميعًا.
هي الوعاء الذي تجري فيه المجرّات، واليد التي تمسك بتوازن الخليقة، والقنديل المعلّق فوق كل روح حتى لو غرقَت في ظلماتها.
ولذلك كان نداءه:
«قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا…»
ليس خطابًا شرعيًا، بل نداءً سماويًا يقف على حدود الغيب، يفتح بابًا بين عالمين:
عالم البشر الذي تتساقط فيه الخطايا كأوراق الخريف،
وعالم الربّ الذي تتساقط فيه الرحمة كأمطار الربيع.
في تلك الدعوة الماورائية معنى آخر:
أنّ الله لا ينتظر توبة عبده ليغفر، بل ينتظر انكسار قلبه ليقترب منه؛
وكأنّ كل دمعة صادقة هي مفتاح يفتح بوابةً من النور،
تتنزّل منها الملائكة تحمل في أجنحتها بردًا وسلامًا على جراح الروح.
وفي الحديث الشريف، ذلك المشهد الإلهي العجيب:
الله يفرح بتوبة عبده…
وكأنّ توبة الإنسان ليست حدثًا أرضيًا، بل اهتزازٌ في العوالم العليا،
رجفة نورٍ في سماء لا نعرف حدودها،
كأنّ الكون نفسه يتسع لحظة الرجوع.
الأنبياء… رُسُل الرحمة المتدثّرة بسرّ السماء
لم يأتِ الأنبياء ليكونوا معلّمي أحكام فقط، بل ليكونوا قنوات نور يتدفّق منها سيل الرحمة الإلهية إلى أرواح البشر.
كانت قلوبهم مرايا تعكس ذلك الفيض العظيم؛ فمن نظر إليهم شعر أنّ الكون نفسه يعتذر له عن قسوته.
وكان محمد النور الأكمل…
لا باعتباره بشرًا فحسب، بل باعتباره تجلّي الرحمة في هيئة إنسان.
كان يمشي بين الناس كأنّ خطاه تُحدث توازنًا في الكون،
وكأنّ كلّ خطوة منه تُعيد ترتيب الفوضى التي أحدثتها الخطايا في القلوب.
قال تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ».
لم تكن رحمته للعرب وحدهم، ولا للمؤمنين وحدهم؛
كانت رحمةً كونية، تمتدّ من حزن الأرملة إلى صراخ الطفل،
من ذنب العاصي إلى ضياع القاتل الذي يبحث عن مخرج من نفسه.
تأمّل دعاءه في الطائف، ذلك الدعاء الذي يظلّل القرون كلها:
بينما الدم يسيل من قدميه، كان نور الرحمة في قلبه أقوى من جرح الجسد،
فقال: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون».
لم يرَ فيهم اعتداءهم… بل جهلهم.
لم يرَ حجارتهم… بل ظلام أرواحهم التي تحتاج قبسًا من نور.
الرحمة… الطريق الذي تعود عليه الأرواح إلى أصلها
إنّ كل توبة هي عودة إلى نقطة الضوء الأولى،
إلى المكان الذي وُلد فيه الإنسان من نفخة الرحمة.
فالله لا ينادي العباد ليتخلّص منهم، بل لينقذهم من أنفسهم،
ولا يطلب رجوعهم ليُحاسبهم، بل ليُعيد إليهم ما سُرق من قلوبهم في متاهات الدنيا.
فالرحمة هي الجسر بين الأرض والسماء،
النهر الذي يجري من الغيب إلى الإنسان،
السرّ الذي يجعل العائد إلى الله يُولد من جديد…
كأنه خرج للتوّ من يد الخالق، نقيًّا، مضيئًا، محمولًا على جناح رحمة لا نهاية لها.