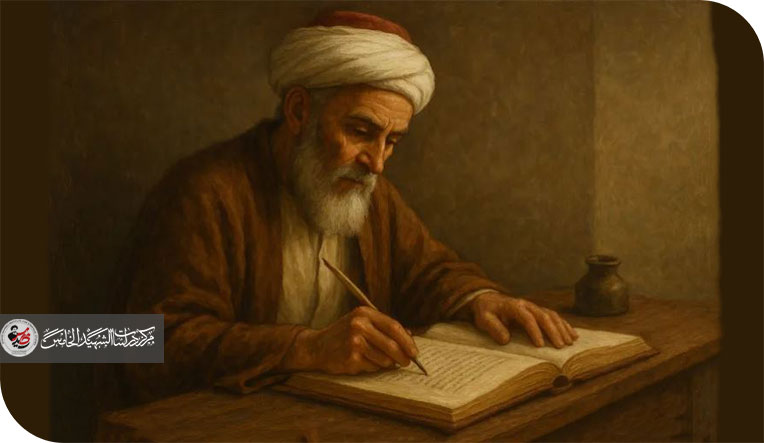تعد المقامة واحداً من أبرز الفنون النثرية الحكائية في الأدب العربي، وهي قصص قصيرة تدور حول بطل وهمي يتسم بالذكاء والدهاء، يرويها راوٍ ثابت، وتعتمد في بنائها على المهارة اللغوية العالية. تهدف من خلال الفكاهة والطرافة الى النقد الاجتماعي ومحاولة لتبيان أثر العادات والتقاليد في مجتمع بغية ترسيخ القيم .
لقد اشتهرت المقامة عند اثنين من أعظم أدباء العربية، واقترن هذا الفن باسميهما: الأول: بديع الزمان الهمذاني (ت398 هـ / 1008م). يُعد هو المبتكر الأول لهذا الفن، وبطله المشهور هو “أبو الفتح الإسكندري” وراويه “عيسى بن هشام”. الثاني الحريري (أبو محمد القاسم) (ت516 هـ / 1122 م). هو الذي بلغ بالمقامة ذروة النضج الفني والزخرفة اللغوية، وبطله هو “أبو زيد السروجي” وراويه “الحارث بن همام”.
تزخر المقامة في الأدب النجفي لدن الأدباء من علماء الحوزة، فيها فسحة لبث لواعج النفس الممتزجة بمخيال القيم والصلاح، ولعل أشهر من كتب المقامة هو:
السيد محمد حسين الكيشوان (-1356ه/ 1937م)
يطالعنا نص أدبي رفيع المستوى يعتمد أسلوب “السجع ” والازدواج، وهو أسلوب شاع في العصور المتأخرة وفي الرسائل والمقامات الأدبية. وبنيته الحوار بينه وبين صاحبه، وأحيانا تلحظ الحوار مع النفس بحاكيها في رحلتها. يمزج الكاتب ببراعة بين الآيات القرآنية، والأحاديث، وكلمات من نهج البلاغة، والأمثال العربية، والأبيات الشعرية في توظيف متمكن أمكن. فهو يحاكي أبيات قصيدة دالية يمازجها بحلو الحديث وطرافة الكلم وينتهي كل مقطع عند صدر أو عجز ملتزما بالتقفية.
يتضمن النص وصف حالة من اليأس والأرق، ثم ينتقل لرحلة خيالية بين الكواكب والنجوم (المشتري، الجوزاء، الثريا) بأسلوب رمزي، كأنها رحلة ما بعد الحياة، او رحلة نحو الحساب، والظفر العقدي لينتهي عند شخصية الامام المنتظر “المهدي بن الحسن” وذكر صفاته من الجود والمروءة والذكاء.
المقامة كتب بها إلى بعض إخوانه قوله[1] :
لا بدع لو أخطأت نهج مقصدي وتهت بين مصدري وموردي
ضللت عن قصدي فقل أي فتى بلا دليل للمساعي يهتدي
ذَهبتْ عَن عَيني يَا إنسانَها بُعداً فَلَم أُبصِر سَبيلَ الرَشدِ
كُنتَ يَدي فجذّها البَينُ ولا يَصولُ ذُو النجدةِ مِن غَيرِ يَدِ
ورُوحيَ الـــــــــــــــــــــــتي انتَزَعتها فَلَم تَبقَ حياةٌ بَعدَها في جَسَدي
قَوسني البَينُ وراشَ بالجَوى سِهاماً لهُ قَرّبَه مِن كَبِدي
والسهمُ لا يَنفذُ إن لَم يَقتَرِب مِن كبدِ القَوسِ لِرَميِ الأبعَدِ
“سهم سدده البين فأصمى كبدي” نزعاً، وأوسع جرح قلبي فضاق صدري ذرعاً، وبت قلق الوساد، أتقلب أرقاً ومثلي يأرق، (ولا تنام العين ذات الرمد).
وانثنيت جرح الفؤاد أتململ قلقاً، ودمعي يترقرق، (حزناً به أوهى بقايا جلدي)
وتفكرت في خطط السماوات والأرض قائلاً: سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلاً، وجعلت أراقب مدار الأفلاك السائرة، وسير الكراة الدائرة (وهي تروح تارة وتغتدي)
على حين قد اتّشحت من البروج بمنطقة، فتجملت بأبهى منظر، وتزينت بمصابيحها المشرقة، فازدهت بلونها الأزهر، «تروق حسناً بالسنا المتقد» ونظرت نظرة في النجوم، وقلت إني سقيم «قد ملني بعد الطبيب عوّدي».
وقيل لي: تالله إنك لفي ضلالك القديم «فاسترشد النجم عسى أن يهتدي».
فقلت: والنجم إذا هوى، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ما ضل صاحبكم وما غوى عن نهج الصراط المستقيم، وإنه بالوادي المقدس طوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لقلبي الكليم، وعهد ذكرني نوحاً، بطوفان دمعي العميم، همّ ألمّ بقلبي فألم، ونادى مستغيثاً بدمعي المرجم، «مصوباً في نفسي المصعد»
فقطر أفلاذ كبدي بمرجل الصدد الذي غلا، وأرخص مني كل نفيس غلا، حتى إذا قرّت زمجرة العبرة، والدمع له فوره، وهدأت نفثة الزفرة، والصدر له سوره «تجيش من حر الزفير الموقد»
أطرت في جو التصور طائر فكري فخفق بجناح التصديق، وحلق إلى سماء الوهم مطلاً على الخيال الدقيق، ورفرف حائماً ليقتنص سرب الرجاء وأنا أمتنع، وانقض على شوارد الآمال بمخالب الطمع، وعاد إلي من النجاح بسلطان مبين، وجاءني من سبأ البشرى بنبأ يقين «أصم وقرأ فيه سمع حسدي»
فهش قلبي لذلك النبأ عجباً، وانشرح صدري له طرباً، وقلت ثقي يا نفسي بالأمل وانتعشي فرحاً، وتطلعي إلى قبة السماء وامشي في الأرض مرحاً (كيما تقومي بالمنى وتقعدي)
واشرئبي إلى السماء واتخذي سلماً في الفضاء، ودعي كل عين ثره، وردي ماء المجرة «فإنه يا نفس أصفى مورد»
وابني له صرحاً من الرجاء، لعلك تبلغين أسباب السموات فتقرئي ما خط لك باللوح والقلم «فتعرفي اليوم علاك في غد»
وارتقبي تصريف القضاء، فللتأخير آفات وفاز باللذة من تجاسر وتكلم (وذو الحيا خاب بكل مشهد)
وهذا الافق مدبج بوشي الخضرة، ودوحة الجوزاء يانعة بالزهرة، طلعها منضود، وظلها ممدود (دانية قطوفها للمجتدي)
أما ترين المشتري أقبل وهو أعزل يستنجد السماك الرامح، ويرنو للنسر بطرف طامح، منعطفاً عليه بلفتة الرقيب. مشيراً إليه بالكف الخضيب، كي يتبوأ من أبراج الفلك مكاناً قصياً، ويلتقط حب العنقود من الثريا، حتى رماه القوس ومال عليه سعد الذابح، وأقبل الدبران بدلوه من نهر المجرة مائح (كيما يبل غلة القلب الصدي)
ثم تمنطق بالجوزاء ورأسه بالنثرة مكلل، وانثنى يحصد السنبلة متخذاً من الهلال منجل، ونصب الميزان لحب الحصيد، وقال هل من مزيد. قلت قتل الخراصون ما لكم كيف تحكمون، فزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك تقدير العزيز العليم (وانقدوا لي ورقاً من عسجد)
فقد صح ما يقولون، رزقكم في السماء وما توعدون، وخيّل إلي أن الكواكب مضروبة دراهم من لجين، فنظرت شزراً إليها، وظننت أني ملكت ما بين الخافقين، فانثنيت مرحاً وتيها، وقلت: والمرء على ثقة من يقينه، وأما من أوتي كتابه بيمينه، فسوف يحاسب حساباً يسيراً، وينقلب إلى أهله مسروراً (بنعمة باقية للأبد)
وتلك غنيمة، مالها من قيمة. فبيدي لها متطاول، وأملي صاعد ونازل ليتناولها بالأنامل، وأين الثريا من يد المتناول (ولا ينال النجم لمساً باليد )
حتى اذا نادى زنجي الغسق بالويل، وصاح رومي الشفق يا ليل، وانجلى الصبح لذي عينين، وأصبحت من الذهب صفر اليدين، خالفت على الحشا وضع الراحتين، ورجعت بخفي حنين، فعادت ملاءتي فارغة الأكمام، ومناط عقلي كثير الأوهام ( وساوس ترددت في خلدي)
ووقفت أعض أناملي من الغيظ. وقوف شحيح، وأردد أنفاسي بأذكى من وهج القيظ. وأنا أصيح، هات دراهمي يا غلامي، فقال انها أضغاث أحلام، فقل أعوذ برب الناس، من شر الوسواس ( وأرق بها السحر ونفث العقد)
فقلت لا أقسم من خجلي بالشفق، والليل وما وسق، والقمر من وجه حبيبي وما اتسق، لتركبن من بضاعتي طبقاً عن طبق، حتى اذا غاب عقلي، وعرفت عقدي وحلي، وأومى لي البشير صبراً، وأسر النجوى وقال لك البشرى، فان تقهقرت عن خطط السماء فهذي خطة الأرض، صراطها مستقيم فتطلب بها سنن العلاء فأما لرفع وأما لخفض والجد مقعد أو مقيم « فانهض لذكر بالثنا مخلد »
وتجول بشقق الفلوات وان بعدت عليك الشقة، وخاطر بنفسك في الهلكات وعرضها للمشقة، وقس خط الأرض ميلاً ميلاً، وتقدم بشوطها قليلاً قليلاً ( كيما تفوت سابقاً للأمد )
فقلت بما أتوسم سنن الأرض، وأتحرى منها البسط والقبض، وعذاب الهموم قد انقض ظهري، فلأسئلن يومئذ عن النعيم، ولا حبل أشد به أزري، في زروع ومقام كريم، فكيف أذرع مقياس البسيطة باعاً باعاً، وأقيس جبالها ذراعاً ذراعاً، وما أغنى الأمل عني بما كسب، فليت نفسي حمالة الحطب « وليت لي حبلاً ولو من مسد »
أمنية لم أزل أردد بها نفسي، والتمني رأس مال المفلس، تحرضني على الطيران وأنا محصوص الجناح، فكيف أهم بأمر الحزم، وقد حيل بين العير والنزوان، وكبا بي الجد عن الجناح فلا ينهض بي العزم، والعاثر لا يجري بشوط السباق ركضاً، ولا يكلف العاجز ما لا يطاق نهوضاً « أنى ولا يرجى قيام المقعد »
فقيل لي: ألم نجعل لك عينين، تبصر بهما قصد السبيل عياناً، ولساناً وشفتين، تدبج بهما المعنى البديع بياناً، فقلت: متى أبصر من مجاز قصدي طريقه، وفي العين قذى، أو أنطق بالحقيقة، وفي الحلق شجى، فها أنا ذا أخبط من الحيرة خبط عشواء، فلا أعرف رشداً ولا غواية، وأتلجلج في الخطابة تلجلج الفأفاء، فلا املك تصريحاً ولا كناية؛ وأرى موضوع فكرتي الشخصية محمولاً بنوع غير مستقيم، ولا أجد لفصله جنساً، وقياس تعريف القضية، مؤلفاً من كل شكل عقيم، فلا ينتج إلا عكساً، « والخلف منه لازم للموعد »
غير اني راجعت فكري أخيراً، فلقاني نضرة وسروراً، وأوحى إلي ان اعتصم من حبل الصبر بما هو خير وأبقى، واستمسك من سلسلة الحزم بالعروة الوثقى، وارتقب يوم فصل القضاء، ان يوم الفصل كان ميقاتاً، يوم ينفخ بصور الرجاء، فيحيي الفضل بعد ما صار رفاتاً، وانتظر رجعة القائم بالمنن، الامام الذي أنزلت بفضله السور، وهو “المهدي بن الحسن”، الغائب المنتظر، ذاك الذي عقدت عليه خناصر المفاخر بالأيادي البيض، فأزالت كل ابهام، وتدفقت أنامل راحته من بحرها الزاخر بجودها المستفيض، فتموجت بالأنعام «طافحة أمواجها للمجتدي»
وتسنم غارب العلياء فملك قيادها، ودعم قبة الشرف فأقام عمادها، وألبسه الفضل تاج الامامة، وخفقت على اكليله ألوية الزعامة، وفتح مملكة الآداب بمواكب المزايا فملك بها العلى، وابتسم له ثغر المجد فهو طلاع الثنايا وابن جلا، ودانت لفضله العرفاء فلا نزاع به ولا خلاف، وملك الأحرار برقيق طبعه الشفاف وخضعت له أعناق القبائل مذعنة لنهيه وأمره وأشارت اليه بالأنامل، متبعة لرأيه وفكره، فلو تنبه لهذا الأمر الخطير، وقطع عنه المعاذير، وجرى باستقامة خط الاخاء، ومثل نصب عينيه صورة الوفاء، لسهل لك عسره، وأقال دونك كل عثره « وكم يد له اذيلت من يد »
فهو المطبوع على المروّه، والمقيم على عهد الاخوه، ولو حل بين العرب لعقدوا له كل حبل، وهو أقرب اليه من حبل الوريد، ولو قطع عنه الكسل لعوّل على الوصل ببسيط جميله المديد، فقلت: اليك عني فلعل له عذراً، أو لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً « فانثنى عنه بعيش رغد »
فلا تلح عليه بما أنت فيه، وأشر له فان الحر تكفيه، والمهدي أهدى من قطاة، ولكن بطرق المكارم، فما تميم من هاشم، وأحيى من فتاة، ولكنه ماضي العزائم فأين عنها الصوارم، وما يدريك لعله بلغ جهده، أو أعدّ لذلك عدّه، ولو لم يتجول من نقطة إلى نقطة، أو يتحول من خطة الى خطة، فهو الذي تعود بسط كفه، حتى باسلاك بها اللؤلؤ الغض منضد، فكيف يقبضها ثاني عطفه، عن جبال من الأرض بها الحصى مبدد، وما أحسبه إلا انه تفطن للقصد وهو الألمعي، وتنبه للأمر وهو اللوذعي.
السيد محمد حسين الكيشوان
السيد محمد حسين بن السيد كاظم بن علي بن أحمد الموسوي القزويني الكاظمي الشهير بالكيشوان (1295- 1356ه/ 1878- 1937م)، عالم كبير، وكاتب مبدع، وشاعر مشهور. ولد في النجف ونشأ بها.
ذكره صاحب الحصون قال[2]: فاضل مشارك في العلوم، سابق في المنثور والمنظوم، له فكرة تخرق الحجب، وهمة دونها الشهب، وشعر يسيل رقه، وخط يشبه العذار دقه، إلى حسن أخلاق، وطيب أعراق، وحلو محاضرة مع الرفاق، ونسك وتقى بعيد عن الرياء والنفاق. وله شعر كثير بديع التركيب
. وذكره الشيخ النقدي[3] فقال: من فضلاء العصر، وشيوخ الأدب، له إلمام تام بجملة العلوم، وله تأليف في بعضها … ونظم الشعر ففاق أقرانه، وشعره يجمع بين المتانة والرقة والانسجام، ومعظمه في مدح ورثاء أجداده المعصومين.”
قال علي الخاقاني: شاعر من الطراز الأوّل بين معاصريه من أرباب الصناعة، وجواد سباق خاض حلبات واسعة فكان الموفق في جميعها، وديوانه وقفت عليه فوجدته عامراً في قصائده، وفي مشاركته بأدب الطف برهن انه من الممتازين بالرثاء ومراثيه نالت اعجاب المولعين بمراثي آل البيت، وقد دونت له عدة مراثي في كتابي (شعراء الحسين) تأتي في الطليعة من أدب الرثاء. ولديه نماذج رائعة في مختلف أنواع الشعر منه في الغزل الديني
[1] – شعراء الغري 8/ 14- 17.
[2] – الحصون المنيعة 9 / 339 .
[3] – الروض النضير ص 250